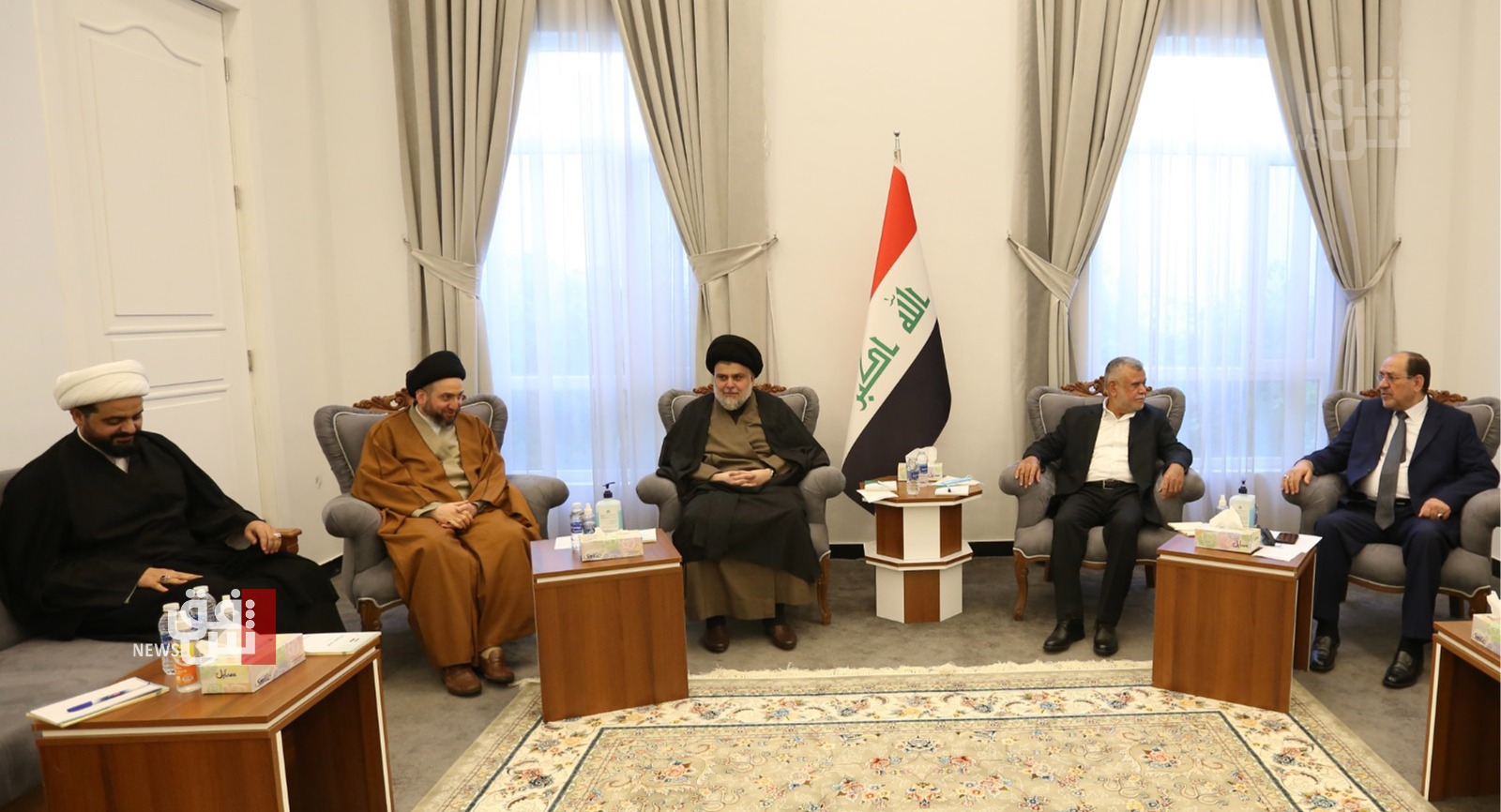العراق بحاجة الى دولة علمانية ديموقراطية وليس دولة مدنية ديموقراطية
زكي رضا
الجميع في العراق يدعو اليوم لما تسمّى بالدولة المدنية، الشيوعيون، القوميون ، الماركسيون، الليبراليون، منظمات المجتمع المدني، النقابات، التشرينيون، العشائر، بل وحتى البعض من الأسلاميين وميليشياتهم!! فهل نحن بحاجة فعلا بعد مرور عشرات العقود على إنشاء الدولة العراقيّة الحديثة بهشاشة نسيجها الأجتماعي وأحتراب مكونّاتها العرقيّة والطائفيّة، وعقدين على تجربة نظام “ديموقراطي” أثبت فشله على كل الصعد لتضاف تجربته المريرة الى فشل أنظمة الحكم العراقية التي سبقته، اقول ، هل نحن بحاجة فعلا الى دولة مدنية ديموقراطية ؟ هذه التي يدعّي جميع من جئنا على ذكرهم العمل لتحقيقها على الرغم من الفروقات الكبيرة بين القوى التي تتبنى هذا المفهوم لشكل الدولة، أم نحن بحاجة الى دولة علمانية ديموقراطية؟
العراق على الصعيد الأجتماعي يتحكّم فيه عاملا الدين/ الطائفة – القومية / العشيرة، ومن خلال هذين العاملين تأتي عوامل أخرى كتحصيل حاصل لدورهما وولاء الغالبية العظمى من الشعب العراقي لهما، نتيجة دور نفس هذين العاملين في ترسيخ التفرقة والتخلف والجهل عن طريق سرقة ما تبقّى من وعي عند الجماهير، علما من أنّ العراقيون لم يغادروا مربّع هذين العاملين منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة لليوم. ومن العوامل التي تساهم في ترسيخ مفهومي الدين/ الطائفة – القومية / العشيرة اليوم، هي أحزاب المحاصصّة الطائفية القوميّة المهيمنة على السلطة منذ الأحتلال حتى هذه اللحظة. ولمّا كانت المؤسستين الدينية/ الطائفية ومعها القومية/ العشائريّة غير قادرتين دستوريّا على تبنّي تعريف محدّد للدولة، فأنّ سلطة المحاصصّة أخذت على عاتقها من خلال هيمنتها على السلطة تعريف شكل الدولة التي تتماشى بالحقيقة مع ما تريده هاتين المؤسستين بما يضمن مصالحهما.
لو نظرنا الى الأحداث التي جرت وتجري في العراق منذ الأحتلال لليوم، لرأينا أنّ كل مناحي الحياة السياسيّة والأجتماعية والأقتصادية مشوّهة بشكل كبير. هذا التشّوه بالحقيقة له جذوره التي سبقت الأحتلال، لكنّ النظام السياسي الجديد لم يعالج كما كان منتظرا منه التشوّهات التي ورثناها من النظام البعثي والأنظمة التي سبقته في بنية الدولة والمجتمع، بل على العكس فأنّ النظام الجديد عمّق تلك التشوّهات خدمة لمصالح نخب سياسيّة وعائلية وعشائريّة على حساب مصالح الجماهير المسحوقة من جهة، ولصالح قوى إقليميّة ودوليّة من جهة ثانية. ولو عدنا الى أسباب أستمرار التشوّهات في ظل السلطة الجديدة سنرى أنّ الدستور العراقي هو الحجر الأساس في هذه التشوّهات، كون هذا الدستور مشوّه ومتناقض في أهمّ فقراته التي تحدد شكل الدولة وهويّتها. فالدستور لم يشر علنا الى أسلاميّة الدولة، الّا أنّه وضع الدولة في إطار أسلامي على المستوى القانوني/ التشريعي، وفي صورة أسلاميّة على المستوى الأجتماعي وحقل التعليم. فالدستور العراقي ينص في مادّته الثانيّة على:
أولّا :-“الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع”
أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام
ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور”.
ثانيا:- يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين .
هذه المادّة الدستوريّة ليست تشوّها في الجسد الديموقراطي للدولة فقط، بل هي أساس قانوني ودستوري لضبابيّة شكل الدولة ونسفها مستقبلا. ولو عدنا الى اللجنة التي كُلّفت بكتابة الدستور فسنرى أنّ النسبة الأكبر من أعضائها هم سياسيّون ورجال دين من ثلاث مجموعات سكّانيّة (شيعة- سنّة – كورد)، مع عدد من ممثّلي الأثنيات العراقيّة الأخرى وعدد قليل من القانونيين والمختصّين كديكور ليس الّا، كونهم غير مؤثرّين لا في هذه اللجنة ولا غيرها. ولكي نتعرف على شكل الدولة التي رسم الأعضاء الواحد والسبعون (عدد أعضاء اللجنة التي كتبت الدستور) ملامحها، فعلينا أن ننتبه الى وجود ممثّل فيها كان له حقّ الفيتو غير المعلن وأملاء ما يريد وتمرير ما يريد وهو السيّد أحمد الصافي النجفي ممثل السيد السيستاني في تلك اللجنة. ولو عدنا الى الدستور العراقي لسنة 1925 لنقارنه بدستور اليوم فسنراه أكثر تقدميّة في هذه المادّة بالذات، فقد نصّ في مادّته الثالثة عشرة من أنّ: “الإسلام دين الدولة الرسمي، وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة لا تُمس، وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة، وحرية القيام بشعائر العبادة، وفقاً لعاداتهم ما لم تكن مخلّة بالأمن والنظام، وما لم تناف الآداب العامة”. “ولا يوجد في هذا النص ما يشير الى علاقة الدين بتشريع القوانين نفياً او ايجاباً. ومن الناحية العملية ظلت الأحكام القانونية تُستمد من أحكام الشريعة الإسلامية سواء في الأحوال الشخصية أو العلاقات العائلية أو في الحقوق المدنية” (1)
من خلال الأشكالية الدستورية أعلاه، وممارسات التيار الأسلامي والمؤسسات الدينية سلطويّا ومجتمعيا , ومن خلال حقل التعليم، علينا البحث عن أجابة لسؤال محدّد هو: هل العراق دولة دينية أم “دولة مدنية” يهيمن عليها الدين من خلال مؤسساته وأحزابه الذين يريدون فرضه أي الدين كأداة للحكم وفلسفة وقيم لقيادة المجتمع، وإن كنّا بحاجة لهما أو لأحدهما كنموذج للحكم للخروج من أزماتنا التي نعيشها اليوم كمواطنين وكبلد يشغل الدين فيه مساحات واسعة من العقل الجمعي لمواطنيه وقوانينه ويرسم سياساته ويؤثّر بشكل كبير على حياة سكّانه الأجتماعيّة، أمْ أنّ الدولة العلمانيّة الديموقراطية هي السبيل الوحيد لبناء دولة عصريّة على أنقاض الدولة “الدينيّة” أو “المدنيّة” التي نعيش خرائبها اليوم؟
الغالبية العظمى من الدول العربيّة والأسلاميّة ومن خلال دساتيرها هي شكل من أشكال الدولة الدينيّة على الرغم من أنّها مدنية الطابع إجتماعيّا وثقافيّا وفكريّا، ولا يخلو دستور فيها من أربعة نصوص رئيسية حول الأسلام وهي: أن يكون الأسلام دين الدولة الرسمي، والأسلام مصدر أساسي للتشريع، والأسلام مصدر من مصادر التشريع، والدولة راعية للدين. والدستور العراقي فيه هذه النصوص جميعها. وتبقى الجمهورية الأسلاميّة الأيرانيّة على سبيل المثال والتي تنصّ مادتها الدستوريّة الرابعة بأن:-
“يجب أن تكون الموازين الإسلامية أساس جميع القوانين والأنظمة المدنية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية والسياسية وغيرها. ويسري هذا المبدأ على جميع مواد الدستور والقوانين والقرارات الأخرى على الإطلاق والعموم، ويتولى الفقهاء في مجلس صيانة الدستور تشخيص ذلك” هي دولة دينيّة دستوريا .
المادّة الدستوريّة الإيرانية هذه هي ترجمة حرفيّة لمفهوم (الحكم بما أنزل الله) والتي يتمّ تفسيرها سياسيّا كي تكون الشريعة الأسلاميّة هي الأساس في بناء المجتمع والأنسان، وهي التي ترسم من قبل الدولة طبيعة الحياة السياسيّة والأجتماعية والفكريّة والأقتصاديّة للمجتمعات الأسلاميّة، وهي التي تملك الوصاية على حقل التعليم وتوجيهه أسلاميّا، وهنا تحديدا تكمن الخطورة. وقد أرجع المودودي القانون الى الله وحده في معرض تفسيره حول حاكميّة الله القانونيّة فكتب “يقرر القرآن الكريم أنّ الطاعة لا بدّ وأن تكون خالصة لله، وأنّه لا بدّ من إتباع قانونه وحده، وحرام على المرء أن يترك هذا القانون ويتّبع قوانين الآخرين أو شرعة ذاته ونزوات نفسه” (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون – البقرة 229 (2) وقد حذا محمد باقر الصدر حذو المودودي في هذا الجانب ليقول “ما دام الله تعالى مصدر السلطات، وكانت الشريعة هي التعبير الموضوعيّ المحدّد عن الله تعالى، فمن الطبيعيّ أنْ تحدّد الطريقة الّتي تُمارَس بها هذه السلطات عن طريق الشريعة الإسلاميّة” (3) وقد ذهب الخميني الى “أنّ القرآن الكريم كتاب قانون، يحمل بين دفتيه أصول الحكم وقواعده، ويستبطن مكوّنات دولة في طبيعة تعاليمه” (4) أمّا عن أسباب التشريع الأسلامي فأنّ “ماهية وكيفية القوانين الإسلامية وأحكام الشرع تدلّ على أنّها قد شرِّعت لإنشاء حكومة ولإدارة سياسية واقتصادية وثقافية للمجتمع” (5)
المؤسسات الدينيّة والأحزاب والمنظمّات الدينية والطائفيّة بالعراق، لم تتطرق لليوم الى شكل الدولة بالبلاد عدا بعض التنظيمات التنظيمات الشيعية، والتنظيمات الأسلاميّة المتطرفة ومنها تنظيمي القاعدة والدولة الأسلاميّة (داعش) الأرهابيين، اللذان دعيا لقيام دولة أسلاميّة يكون الحكم فيها لله أي وفق الشريعة. الا أنّ المؤسسات الدينية وغالبية الأحزاب والمنظمات الدينية الأخرى لم تبدِ وجهة نظرها بشكل علني حول شكل الدولة لظروف موضوعية تمر بها البلاد وليس لعوامل ذاتية، لذا نراها تعمل في المنطقة الرمادية لحين قدرتها على تغيير شكل الدولة نحو الدولة الثيوقراطيّة أي الدينية كما إيران وتنظيم الدولة أي داعش، مع التركيز على أنّ شكل الدولة وهي تحت سيطرة الأحزاب والمؤسسات الدينية ومراجعها يلتقي بشكل أو بآخر مع أهداف داعش من حيث العودة للقرآن والشريعة كوسيلة للحكم وبناء الدولة. لكنّه يختلف عنه بالعراق حيث الثقل الشيعي وميل واضح لغالبية التنظيمات السياسية الشيعية نحو الجمهورية الأسلامية الايرانية كنموذج يحتذى به لبناء دولة على غرار الدولة الأيرانية، أي دولة ولي الفقيه. وقد أكّد الخميني أنّ حق الحاكمية بعد الله كانت للنبي ثمّ “أنتقلت مسؤولية القيادة السياسية للمجتمع بعد النبي الى الأئمّة المعصومين” (6). وقد أوكل الله وفق وجهة نظر الخميني حقّ الحاكمية بعد النبي وأئمة أهل البيت بعدهم الى علماء الدين الذين ليس لغيرهم الحقّ في الحكم وهم “المصداق الحقيقي لأولي الأمر” (7)، وفي تشكيل حكومة عصر الغيبة يقول “عرّف الأمام المعصوم (عج) الفقهاء العدول بوصفهم قادة سياسيين للمجتمع والمسؤولين عن تشكيل الحكومة” (8). وقد كان يوسف القرضاوي شديد الوضوح وهو يكتب “فالحق أن الدولة الإسلامية: دولة مدنية، ككل الدول المدنية، لا يميزها عن غيرها إلا أن مرجعيتها الشريعة الإسلامية”!! (9)
هناك من يعتقد ومنهم سياسيّون ومثقفون من أنّ العراق بعيد كل البعد عن دولة ولي الفقيه لأنّ المرجعيّة الدينيّة في النجف لا تؤمن بمبدأ ولاية الفقيه، لكنّ هؤلاء لا يمتلكون الأجابة الدقيقة عن موقف مرجعيّة النجف بعد وفاة السيستاني من هذا الأمر، وبدأ الصراع لأنتخاب مرجع أعلى للشيعة بالعراق ودور إيران في حسم الصراع لصالحها عن طريق تأثيراتها الظاهر منها والباطن، متناسين على ما يبدو من أنّ التفسير الشيعي لمن له الأهليّة في قيادة الدولة إنتظارا لظهور المهدي، ينبع من إيمانها في أنّ الإمامة هي إمتداد للنبوّة، وأنّ المرجعيّة الدينية هي التي عليها قيادة الدولة والمجتمع إنتظارا لظهور المهدي المنتظر، أي أنّ المرجعيّة هي من تحدد شكل الدولة وهيكليتها وهي من تقودها، والتي ستكون بعد وفاة السيستاني أي مرجعيّة النجف إيرانيّة في فتاواها ونهجها بقوّة الأحزاب الشيعيّة تشريعيا وتنفيذيّا وبسطوة ميليشياتها “العراقيّة” المسلحّة التي أخترقت جسد “الدولة” العراقيّة.
الأسلام السياسي ومعه مؤسساته الدينيّة اليوم يعملون على قدم وساق لتشويه العلمانيّة بإعتبارها مناهضة للدين ومصادِرة لحقوق المؤمنين، ويسخّرون في هذا الأتجاه كل طاقاتهم الفكريّة والأعلاميّة ومنها منابرهم الدينيّة لتكفير العلمانيّة كنظام للحكم. فهل نحن بحاجة الى “دولة مدنيّة” كتلك التي يتعايش الإسلاميّون اليوم معها، أم الى دولة علمانيّة ديموقراطيّة لتكن بوابّة لبناء عراق جديد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نظرة مقارنة في دستور (1925) ودستور (2005)، عبد الغني الدلي (وزير سابق) صحيفة المدى
(2) ابو علي المودودي، الخلافة والملك، دار القلم الكويت، تعريب أحمد إدريس، ص 16
(3) نظرية الدولة في الإسلام، سلسلة دروس في فكر الشهيد الصدر ، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
(4) صحيفة النور 17: 252.
(5) الإمام الخميني، ولاية الفقيه: 28.
(6) الإمام الخميني، ولاية الفقيه: 51.
(7) الإمام الخميني، كشف الأسرار: 221 ـ 223.
(8) المصدر نفسه: 223.
(9) يوسف القرضاوي مقالة تحت عنوان ” دولة مدنية مرجعيتها الإسلام.. كيف؟
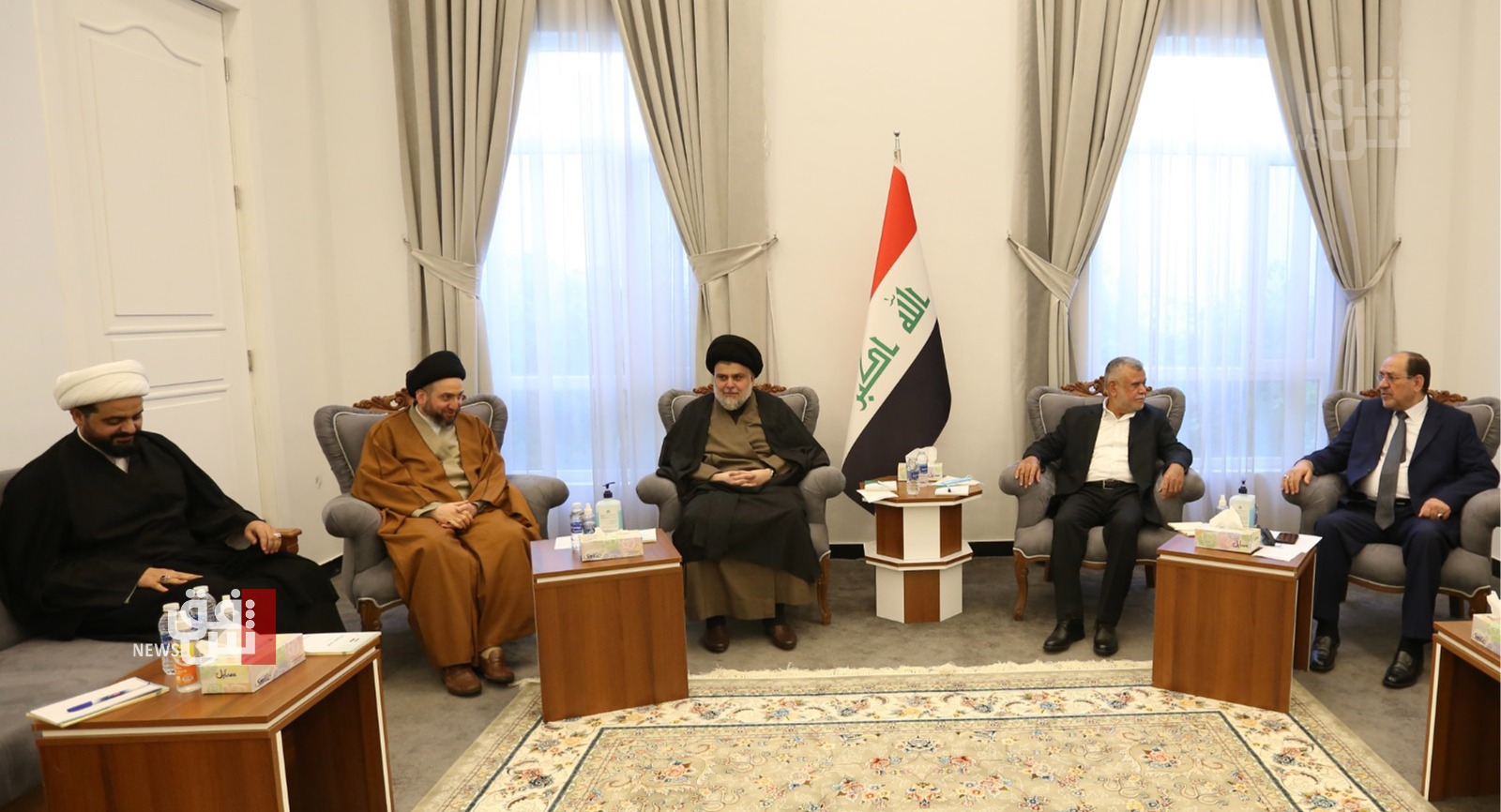
العراق بحاجة الى دولة علمانية ديموقراطية وليس دولة مدنية ديموقراطية
الحلقة 2
القوى الديموقراطيّة العراقية لم تتبنى لليوم في برامجها السياسية وأنظمتها الداخلية وهي تعمل على أنهاء نظام المحاصصة الطائفية القومية ، شعار الدولة العلمانية الديموقراطية، ولازالت ترفع شعار الدولة المدنية الديموقراطية كبديل لنظام المحاصصة، وهذا الشعار أشبه بالدواء الذي يهدئ آلام المريض دون علاجه، كما وأنّ نظام المحاصصة ليس ببعيد عن مفهوم الدولة المدنية من وجهة نظر الإسلاميين وشركائهم في السلطة. فنظام المحاصصة يطرح نفسه على أنّه ليس بنظام ديني بل أقرب الى المدنية، ويمنح القوى التي تصف نفسها بالمدنية هامش “كبير” من الحريّة والتي هي بالحقيقة مقنّنة وتتحرك ضمن أطر وخطوط حمراء لا تستطيع القوى الديموقراطية تجاوزها لتكون مؤثرّة في الحياة الأجتماعية والسياسية للبلاد، لا من خلال الأنتخابات التي لا تستطيع أي القوى الديموقراطية التي تطرح نفسها كقوى مدنية من إختراقها لصياغة السلطة مجموعة قوانين تحول دون حضور فاعل للقوى الديموقراطية في المشهد السياسي العراقي ومنه البرلمان من جهة، ولا من خلال العمل الجماهيري لغياب وحدة هذه القوى وتبنيها برنامج إنقاذ وطني في مواجهة قوى السلطة الفاسدة من جهة ثانية، ولغياب الوعي الأنتخابي وضعف الإنتماء الوطني مقارنة بالإنتماءات الدينية والطائفية والقومية والعشائرية لجماهير واسعة من أبناء العراق من جهة ثالثة. وكمدخل للتمييز بين ما تسمّى بالدولة المدنية والدولة العلمانية نرى أن لا ضير في العودة الى تعريفات اللغة لهما.
المدنيّة كما جاء في معجم المعاني الجامع إسم وهي: الجانب المادّي من الحضارة كالعمران ووسائل الإتصّال والترفيه، يقابلها الجانب الفكري والرّوحي والخلقيّ من الحضارة، وتعني كذلك الحضارة وإتّساع العمران. مدني: (اسم) منسوب إلى مَدينة، خاص بالمواطن أو بمجموع المواطنين، عكس عسكري. وقد تناول المعجم جملة من التعريفات المدنيّة كالقانون المدني، الدفاع المدني، الموت المدني، الطيران المدني، الحقوق المدنية، التربية المدنية، الحريات المدنية، المجتمع المدني، الخدمة المدنية والزواج المدني، ولم تتطرق معاجم اللغة مطلقا الى ما تسمى بالدولة المدنية. فالمدنية والمدني والمتمدّن يقابلها بالأنجليزية كلمة Civil، وهي غير كلمة العلمانية أو اللادينية في المعاجم الأنجليزية أي Secular ، أما Secularism المشتقة من التي قبلها، فأنها تعني نظام دولة لا يلعب فيه الدين أي دور في تنظيم حياة المجتمع ولا دور له في البنية الأساسية في بناء ونهضة المجتمعات والدول الناجحة أي التعليم. كما وأننا لا نجد هذا المصطلح أو تعريفا له في المراكز البحثية الغربية ولا في حقلي العلوم السياسية والفلسفية.
ما تسمّى بالدولة المدنية ليست ضد أن يكون للدين دورا في الدساتير والقوانين التي تنظم حياة الناس الأجتماعية، كما ولا تقف أمام أن يكون للدين دورا في المناهج التعليمية خلال المراحل الدراسية المختلفة وصبغ التعليم بصبغة دينية، أو بصبغة يكون فيها للدين دور واضح وملموس فيها، وهذا ما يدفع الأسلاميون ومنهم أسلاميّو العراق للتواجد في المنطقة الرمادية وهم يتعاملون مع خطاب القوى الديموقراطية الواقعة في فخ ما تسمّيه الدولة المدنية من جهة، ومع منظمات المجتمع المدني ويخترقونها ويشترون ذمم بعض الناشطين فيها كما حدث مع بعض ناشطي أنتفاضة تشرين خدمة لمشروعهم المستقبلي أي أسلمة الدولة، وهذا ما يدفعنا للتساؤل حول إن كانت القوى الديموقراطية تريد بناء دولة متقدمة على أنقاض دولة المحاصصة التي دمرّت البلاد وستقوده للخراب فيما أذا أستمرت في السلطة، أم سترفع شعار تحقيق الدولة العلمانية الديموقراطية وتعمل من أجله بأعتبارها الطريق المفضي لتحرر البلاد من قبضة الفساد والفقر والجهل وسطوة الميليشيات المسلحة؟
الأسلاميون يستطيعون العيش مع ما يُطلق عليه الدولة المدنية، لكنّهم يُحشدّون كل قواهم ضد العلمانية والعلمانيين والدولة العلمانية. وكوسيلة لبدء هجومهم عليها يروّجون على أنّ العلمانية ظهرت في الغرب لمواجهة الكنيسة التي كانت تحتكر الدين وتبيع صكوك الغفران، وأنّ الاسلام لا يمتلك النظام الكهنوتي كما المسيحية، وأنّها ظهرت في الغرب لكسر هيمنة الكنيسة والتحرر من أغلالها. وكأننا في العراق على سبيل المثال وغيره من البلدان العربية ، لسنا مقيّدين بفتاوى المؤسسات الدينية وتدخلاتها في الشؤون السياسية خدمة للمشروع الأسلامي الذي لم يستطع أن يقدّم لليوم نموذجا ناجحا واحدا في أي بلد عربي، علما أنّ جميع المؤسسات الدينية تعمل لصالح النخب السياسية ومصالحها في بلدانها وتمجّد صفوة رجال الدين وتمنحهم صفة القداسة، ومن خلال قداسة هؤلاء ووقفوهم الى جانب السياسيين كما في جميع مراحل التاريخ الأسلامي فأنّها تنشر العبودية في المجتمع وتتّهم بشكل غير مباشر من يناهضهم ويناهض الحكّام على أنّهم كفرة أي علمانيين بالمعنى السياسي للكلمة. وفي هذا الصدد يقول جان بودان في مؤلفه كتب الجمهوريات الستة: “بما أنّه لا يوجد أي أحد أكبر في الأرض بعد الله غير الأمراء السياديين، وإنّ الله أختارهم ضبّاطّا ليقودوا الناس الآخرين، فأنّ الحاجة ضرورية للنظر في مكانتهم من أجل أحترام جلالتهم بكلّ طواعيّة، والأحساس بهم والتحدث عنهم بكلّ شرف، لأن الذي يحتقر أميره صاحب السيادة يحتقر الله الذي هو صورته على الأرض”. وإن كانت الكنيسة قد باعت صكوك الغفران لسرقة المؤمنين المسيحيين البسطاء، فأنّ المؤسسات الدينية ومن خلال فتاواها ولسرقة المؤمنين المسلمين البسطاء تحث الناس على طاعتها وبالتالي طاعة الأنظمة التي تعمل هذه المؤسسات لصالحها، فترسم لهم عالم آخروي جميل خال من الظلم والأضطهاد ليعيشوا حياة ملؤها الظلم والأضطهاد والفقر والمرض والجهل والتخلف في حياتهم الدنيا، وهذا بحد ذاته شكل من أشكال صكوك الغفران. وأذا تركنا التفسير اللغوي لأسم كهنوت وهو وظيفة الكاهن ومصدر الكهانة أي معرفة الأسرار أو أحوال الغيب، فأن رجال الدين الأسلامي اليوم هم أقرب الى الكهنة والكهنوت كما الكهنة والكهنوت في مختلف الأديان.
لقد ظهر مصطلح الدولة المدنية بوضوح وقوّة إثر ثورات الربيع العربي التي لم تنجح في إحداث تغييرات حقيقية في أيّ بلد عربي الّا بشكل جزئي في تونس مهد ثورات الربيع العربي، أمّا في أوربا فأنّ مصطلح المجتمع المدني وليس الدولة المدنية بدأ التداول به في القرن السابع عشر من قبل فلاسفة العقد الأجتماعي مقابل نظرية الحقّ الإلهي كتوماس هوبز وجون لوك وهيغل وماركس وغيرهم وغرامشي في العصر الحديث.
أنّ ما تسمّى بالدولة المدنية مصطلح حديث (عربي) يرجع أساسه لأستنتاجات غير علميّة لنظرية الحكومة المدنية لجون لوك، وإلى توافق غير معلن بين القوى الإسلامية كي لا تتّهم من أنّها تعمل لبناء دولة دينية إسلامية، والقوى الديموقراطية التي تخاف من طرح العلمانية كمبدأ نتيجة تكفير الإسلاميين للعلمانية والعلمانيين وإعتبارهم ملحدين. ولا وجود لها كما قلنا في أي معجم سياسي غربي أو مركز بحثي مهتم بالعلوم السياسية والفلسفية.
والدولة المدنية التي تريدها القوى الديموقراطية العراقيّة كبديل لنظام المحاصصة، لا تعالج أهم نقطة في بناء مجتمع جديد ومن ثم دولة جديدة وهو فصل الدين عن الدولة. أنّ أي تغيير سياسي لا يستحدث آليات سياسية وأجتماعية وأقتصادية وفكرية لنقل المجتمع للأمام وبناء جديد للدولة، هو تغيير فوقي وإستمرار للحالة السياسية التي سبقت التغيير من خلال عدم حلّ المشاكل التي كانت سببا لهذا التغيير ودافعا لحصوله. ومثلما لم تستطع قوى المحاصصة إستحداث الآليات السياسية والأجتماعية والأقتصادية والفكرية لبناء دولة عصريّة، فأنّ القوى الديموقراطية لن تكون قادرة هي الأخرى على إستحداث هذه الآليات من خلال ما يطلق عليه الدولة المدنية التي ترفع شعارها، لأنّها بحاجة الى تحقيق نقطة لا تستطيع “الدولة المدنية” تحقيقها وهي الفصل الكامل للدين عن الدولة كمقدمة لتفكيك أهم حليف للمؤسسة الدينية والقوى الطائفيّة أي المؤسسة العشائرية. وهذه المهمّة التي هي الحل الوحيد لأنقاذ العراق لا تأتي الّا عبر نظام عَلماني ديموقراطي حقيقي، يأخذ على عاتقه بناء مجتمع وفق آليات تختلف عن الآليات التي سبق وأن استخدمتها السلطات العراقية السابقة ومنها سلطة المحاصصة.
أنّ قيام نظام علماني ديموقراطي بالعراق سيقدّم أكبر خدمة للدين، بعد أن جعله الأسلاميّون ومنهم معممّون ومؤسسات دينية في وجه مدافع الإنتقادات، بنشرهم الفساد والفقر والجهل وقمع الحريّات وما ينتج عنها من آفات إجتماعية وخراب أقتصادي وأستعباد الناس، عن طريق منع الدين والمؤسسة الدينية للعب أي دور في مجال التعليم بإعتباره الركيزة الأساسية لبناء دولة متقدمة، لذا نرى إصرار الأحزاب الأسلامية ومعها المؤسسات الدينية على تدمير التعليم بالبلاد، عن طريق إضعاف المدارس والجامعات العراقية التي كانت يوما في مستوى متقدم عن طريق إنتشار المدارس والجامعات الأهليّة التي تمتلكها مؤسسات دينية وشخصيات من هذه الأحزاب، والتي يلعب الدين الطائفي والمفاهيم القوميّة في مناهجها دورا كبيرا. ومن خلال تجربة عراق المحاصصة اليوم نرى ضعف الدولة في مجال التعليم وعدم إمكانيتها في تطبيق نظام تعليمي حقيقي وموحّد بالبلاد، وترك الأمر لأهواء مالكي المدارس والجامعات الأهلية، الذين يبحثون عن الربح مع إستخدامهم المناهج التعليمية وفضاء هذه المدارس والجامعات كحاضنة آيديولوجية.
ويتجاهل الإسلاميون أن العلمانيّة حين تدعو إلى فصل الدين عن الدولة، تكون قد جنّبت سقوط الدين في معتركات المصالح السياسية وتقلباتها، والتي تؤدي إلى تشويه صورة الدين في حال تم استخدامه في ألاعيب السياسة، وعن هذا كتب الفيلسوف الإنجليزي جون لوك قائلا:”من أجل الوصول إلى دين صحيح، ينبغي على الدولة أن تتسامح مع جميع أشكال الاعتقاد دينيًا أو فكريًا أو اجتماعيًا، ويجب أن تنشغل في الإدارة العملية وحكم المجتمع فقط، لا أن تُنهك نفسها في فرض هذا الاعتقاد ومنع ذلك التصرف. يجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة، وألا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر. هكذا يكون العصر هو عصر العقل، ولأول مرة في التاريخ البشري سيكون الناس أحراراً، وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة”، وإذا ما أردنا أن نطبّق مقولة لوك هذه بالعراق فنستطيع القول “يجب أن تكون الدولة منفصلة عن المؤسسة الدينيّة، والّا يتدخل أيّ منهما في شؤون الآخر. هكذا يكون العصر العراقي القادم عصر العقل، ولأوّل مرّة في تاريخ العراق الحديث سيكون الناس أحرارا وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة”.
الدولة العلمانية الديموقراطية ليست معادية للدين والتديّن، بل على العكس فأنّها ومن خلال قوانين حريّة الرأي والمعتقد والفكر والضمير تمنح المؤمنين وغير المؤمنين حقوقا على قدم المساواة دينيا، كما تمنح أبناء شعبها من القوميات والأثنيات المختلفة حقوقا متساوية أيضا. ومثلما توفّر الحماية للمؤمنين قانونيا فهي توفّر الحماية للملحدين من خلال مبدأ حريّة الرأي والمعتقد والضمير. أنّ الحروب الدينية الطائفية والحروب القومية معدومة تقريبا في ظل العلمانية الديموقراطية وهذا ما نحتاجه فعلا بالعراق اليوم، كون الطائفتين المسلمتين خاضتا ولأوّل مرة في تاريخ العراق الحديث حربا حقيقية وتتخندقان اليوم مقابل بعضهما البعض، وخلافاتهما الفقهية والتي يستغلّها ساسة الطائفتين مع خطر المواجهة القومية بين العرب والكورد، يهددان بتقسيم البلاد كما حصل في السودان ويوغسلافيا والهند وبعدها إنفصال بنغلاديش عن باكستان. وسيبقى الفصل القانوني وفق الدستور بين الدين والسياسة، والتعليم بفصله التام عن التأثيرات الدينية لأي دين أو طائفة، مهمّة لا ينجح بها الا نظام علماني ديموقراطي، مع الأخذ بنظر الأعتبار من أننا بحاجة الى دستور يكتبه فقهاء قانون وليس فقهاء دين.
العلمانية كنظام للحكم لم تظهر دون مخاض سياسي وأقتصادي وأجتماعي وأخلاقي خاضته البشرية طوال تاريخها، بل تطورت على أنقاض أنظمة الحكم المختلفة منذ العبودية لليوم، ونجح الراهب مارتن لوثر على سبيل المثال في نضاله ضد الكنيسة الكاثوليكية التي سنّت صكوك الغفران كوسيلة لإثراء كهنتها، عندما بيّن للناس أن سلوك الكنيسة كان بعيدا عن تعاليم الكتاب المقدس. فهل هناك مرجع ديني أو مصلح ديني أو سياسي قادر اليوم وللحفاظ على الدين والمذهب ان يبيّن للناس أنّ سلوك رجال الدين والساسة الإسلاميين هو على الضد ممّا جاء في القرآن، وأنّ هيمنتهم على السلطة ما هو الا اثراء لهم وإساءة للدين الذي يؤمن به الفقراء المؤمنون، كما كان الفقراء المسيحيّون المؤمنون وقتها؟
والآن فهل نحن بحاجة الى “دولة مدنية ديموقراطيّة” أم الى دولة علمانيّة ديموقراطية ..؟ سؤال موجّه الى القوى والمنظمّات السياسية التي على عاتقها يقع إنقاذ العراق وشعبه من شرور المحاصصة الطائفيّة القومية.
لا يمكن تحطيم اي شكل من أشكال العبودية إلا بتحطيم كل أشكال العبودية … (كارل ماركس، نقد فلسفة الحق عند هيغل)