قيس الزبيدي:
الفنان الذي خلق وثيقته
د. فيصل درّاج
مدخل:
وجدت صحيفة ( صوت الصعاليك ) من الأهمية بمكان نشر هذه الموضوعة المتعلقة بكتاب المخرج السينمائي الفنان قيس الزبيدي الموسوم “فلسطين في السينما” 2006
والذي وضع الصديق الأستاذ فيصل درّاج مقدّمته، ضمّ البطاقة التقنية والفنية الخاصّة ب799 فيلماً لمخرجين فلسطينيين وعرب وأجانب.. تجدر الإشارة الى أن الصحيفة وموقعها قد نشرا العديد من المقالات المتعلقة بمسيرة الفنان الزبيدي ، وستصدر لاحقا مدونة تتضمن تلك المقالات بالإضافة الى صور وبلاكارتات تتناول كتبه والافلام التي قام باخراجها أو ساهم بإنتاجها ..
نرجو ممن لديه بعض الوثائق والمقالات والصور المتعلقة بهذا الفنان القدير، التفضل بالتواصل معنا على مايل الصحيفة.
مع جزيل الشكر والتقدير
![]()
قبل خمسة وعشرين عاماً تقريباً، جاء قيس الزبيدي إلى بيروت، حاملاً أحلاماً طريدة. كان مغترباً كغيره، وغريباً عن عراق مَكر به، علّمه توليد الأحلام ودفنها. غير أنَّ من بدا كغيره تكشّف، بعد حين، مختلفاً، يقاسم غيره المنفى ويحتفظ لذاته بأشواق غامضة. كان في ذلك الفنان، الهامس الصوت، ما يوحي بغريب مختلف، يكتب عن بريشت ويترجمه ويقارب موضوع »المونتاج« بشغف، ويتحدث البعض عن فيلمه »اليازرلي« باحترام كبير. غير أن قيس، الذي رحل عن وطنه، لم يقبل بترحيل أحلامه كلها، فقد ارتضى بأحلام مجزوءة وذهب إلى القضية الفلسطينية. قاسم الفلسطينيين غربتهم وخفّف الفلسطينيون من غربته. وتقاسم الطرفان قضية عادلة، تحتمل المقاتل – الشهيد والفنان الصادق إلى حدود الشهادة.
لم يكن قيس، ربما، مشغولاً بالعراقي، الذي كانه، ولا بالفلسطيني، الذي صاره، كان مأخوذاً بعلاقتين أكثر أهمية: الإنسان الحر المدافع عن قضية عادلة، والفنان العادل الذي ينصر المدافعين عن الحرية. وفي فضاء هاتين العلاقتين سار قيس زمناً وطار في زمن آخر، وتذكّر العراق وأحلامه الأولى في أزمنة كثيرة. وعن هذه الأزمنة، التي يتمازج فيها الشغف والحنين والإحباط، صدرت السيرة السينمائية للقضية الفلسطينية، التي صاغها المنفي العراقي بدأب وصبر واجتهاد، حتى غدا أب السيرة الوحيد، وأصبحت السيرة امتداداً نجيباً له، في انتظار زمن لا يخذل فيه الأحفاد أجدادهم.
كتب قيس، سينمائياً، السيرة الفلسطينية، وكتبت الأخيرة أشياء من سيرته، مع فرق يفصل بين الطرفين: كتب قيس السيرة كاملة، في أفلام متعاقبة، تسرد ما جرى، وتترك الجواب معلقاً في فضاء الاحتمال، وكتبت القضية الفلسطينية سيرته بشكل مجزوء، ذلك أن الحالم المغترب وزع ذاته على اتجاهات مختلفة، تبدأ بالعراق وتنتهي إلى لا مكان. بقي ينتظر زمناً مخادعاً، يوحد بين زمن البراءة الأولى وأشجان الكهولة، ويجمع بين الوطن والرغبة وصناعة الأفلام، وظل يرى إلى زمن يعالج ما انقسم ويحرّر المغترب من انقسامات كثيرة. وهذه الأزمنة، التي تأتي ولا تأتي، جعلت قيس يكتب، على طريقته، سيرة القضية الفلسطينية، تاركاً وراءه سيرة ذاتية مرتبكة، يحنو عليها الزمن ويعبث بأوراقها في آن.
مهما تكن سطوة الزمن، التي تفصل بين السائر والطريق، فقد أنجز قيس عملاً ثميناً، حين أدرك معنى الاختلاف ومارس إدراكه بشكل مختلف. أدرك الاختلاف بين الفلسطيني الحالم بالأمان والجندي الإسرائيلي الذي يبني أمانه على إعدام أمن الآخرين، وعيّن المسافة بين قول إعلامي سريع الذبول ورسالة فنية، تؤسس لمكتبة مفيدة قادمة. »لا جديد تحت الشمس« يقال في الحاضر والماضي. خلق العراقي المنفيّ، الذي اختلف إلى دمشق وبيروت وبرلين، جديده، مستنجداً بالثقافة والقيم والتضامن مع الآخرين، كأن فيه، وهو الباحث عن مكان تحت الشمس، شمساً صغيرة، تقاسمها مع غيره، في الأيام المشمسة والغائمة.
السينما والمؤرّخ الآخر:
سجّل المؤرخ الفلسطيني، في مراتبه المختلفة، المأساة الفلسطينية منذ بداية القرن العشرين حتى نهايته محيلاً، لزوماً، على أسماء محمد عزة دروزة وعبد الوهاب الكيالي وماهر الشريف وغيرهم.. والمؤرخ، في جهده المكتوب، يتعامل مع منطق بحثي يُلزمه بالتوقف أمام الوقائع الكبرى (1917، 1936، 1948، 1982. ..) وتفسير الأسباب المختلفة التي أنتجتها والآثار المتعددة التي صدرت عنها. ينشغل المؤرخ بكشف العلة والمعلول في الواقعة التاريخية، مُعْرضاً عن وجوه البر وأسمائهم، باستثناء أسماء قليلة ذات سلطة، تنطق باسم مجموع بشري مهم لا يُرى، تعرف أحواله أحياناً وتجهل أحواله في معظم الأحيان.
قصد قيس الزبيدي، مقترباً من الروائي ومبتعداً عنه معاً، إلى شكل آخر من التاريخ الفلسطيني، لا يُكتب بالحبر والورق والفرضيات النظرية، بل بالكاميرا والأشرطة والعين السينمائية.. وبسبب اختلاف الأداة يقدّم قيس معالجة أخرى، تتضمن ما يقوله المؤرخ وتفيض عليه، ذلك أنه ينطلق من أوضاع الإنسان المضطهد المشخصة، كما تسردها عيناه وصوته وبطولة المونتاج، مبتعداً عن مؤرخ مشغول بالمقولات والمفاهيم. يذهب المؤرخ الفلسطيني إلى أسباب المأساة الفلسطينية وآفاقها، ويستنطق قيس معنى المأساة في ذاتها، التي تعلن عنها العيون والأصوات الجريحة والجثث الموزّعة في دروب مختلفة. كأن المؤرخ، الذي يذهب من وثيقة مكتوبة إلى أخرى، يخاطب العقل، أو جزءاً منه، على خلاف الفنان الرهيف الذي يخاطب العقل والروح، معتمداً وثيقة نوعية، تعيد خلق الوثائق المتعددة التي سبقتها. ولهذا يكون قيس الزبيدي مؤرخاً مرتين: يتكئ على ما جاء به التاريخ المكتوب، ويعيد ترتيب وتكوين وشرح ما قال به المؤرخ. وهو في الحالين مؤرخ فلسطيني بامتياز، ومؤرخ الأرواح الحزينة، التي تقاتل من أجل عدل مراوغ، كلما اقترب المغترب منه زاد بعداً.
منذ ربع قرن من الزمن تقريباً، انصرف قيس الزبيدي، وهو لاجئ ومغترب بدوره، إلى تأريخ التراجيديا الفلسطينية سينمائياً، منتهياً إلى نص فني واسع، يسأل ويحاور ويوحي، وإلى وثيقة شاسعة تعرف الماضي وتتوجه إلى المستقبل. وفي هذا النص – الوثيقة، تتكشّف التراجيديا في تعاقبها الزمني، فبعد كل ظلم يأتي آخر أشد وألعن، وتتجلى عارية في مجاز المجزرة، أو المجزرة – المجاز، التي تفتح الدفتر الفلسطيني الدامي وتغلق صفحاته، التي ترفض الانغلاق. يظهر قيس، في الحالين، مؤرخاً من نوع غريب، »يُمَنْتج« وثيقة المؤرخ، وشاهداً أخلاقياً نزيهاً، يردّ على الذاكرة المجرمة بذاكرة مقاوِمة مغايرة، كما لو كان، وهو السينمائي الشامل، يصوغ ذاكرة الفلسطينيين، ويناشدهم ألاّ يفقدون الذاكرة.
يمزج قيس الزبيدي في نصه الفني – الأخلاقي الكبير الأزمنة الفلسطينية المختلفة، دون أن يمنعه ذلك، من كتابة التاريخ الفلسطيني التعاقبي، الذي افتتحه القرن العشرين المنقضي بمأساة متوالدة، ووضع فيه ملحمة قسرية تستولد التفاؤل زمناً وتدفنه في أزمنة لاحقة. فهو في فيلمه الطويل – 81 دقيقة-، »فلسطين سجل شعب«، يضع مادة وثائقية مدهشة، تعتمد الوثيقة والتعليق العلمي وشهادات حية، عارفة نزيهة. يتقدم الفيلم، في مستوياته المتعددة، نصاً إيضاحياً – تثقيفياً موحياً، كما لو كان يكتب بالوثيقة السينمائية ما كتبه المؤرخ بالحبر والورق والمفاهيم. وربما انشغال الفيلم بالدقة المعرفية، هو الذي أملى عليه أن يُدرج في مادته حوارات مع مؤرخين محترفين، مثل محمد عزة دروزة وأكرم زعيتر وإميل توما، والأخير هو الذي كتب تعليق الفيلم، مستنداً إلى معرفة عميقة بتاريخ فلسطين القديم والحديث. وواقع الأمر، أن في عمل الزبيدي التوثيقي ما يردّ على أطروحة صهيونية، تدّعي »يهودية الأرض الفلسطينية منذ زمن سحيق«، منكرة وجود الإنسان العربي في حقول عمرانية كثيرة. ففي مقابل تاريخ صهيوني مصطنع، يجمّد التاريخ في لحظة أسطورية غابرة منه، تبرهن الوثيقة السينمائية، بلغة الجمع، وحدة الإنسان العربي ومكانه، محيلة على تاريخ يعيشه فلاّح فلسطيني مجتهد، يزرع أرضاً له، كما أشار مكسيم رودنسون ذات مرة، ولا ينتظر »كيبوتساً«، يعلّمه الزراعة أو الجود عليه برزق يومي مزوّر. يبدأ الفيلم من تاريخ عربي قديم ويصل إلى العقود الأخيرة من القرن العشرين.
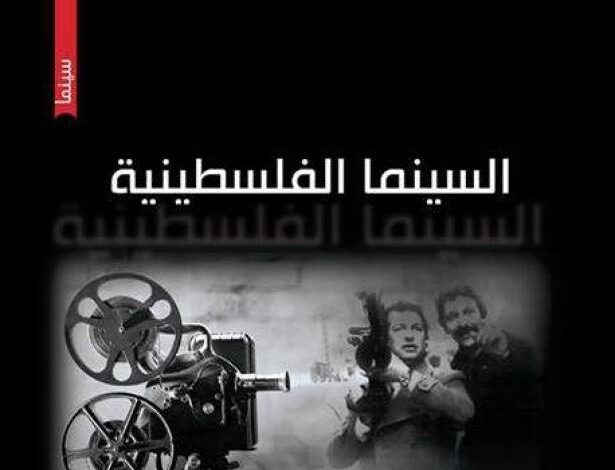
بيد أن قيس، الذي يستولد وثيقته من عيون البشر الحزينة، يعيد كتابة »فلسطين سجل شعب« مرة أخرى في فيلم آخرهو: »وطن الأسلاك الشائكة«. يكشف هذا العمل، على مستوى المعنى، عن انتقال فلسطين من زمن البراءة، حيث الفلاح الفلسطيني منصرف إلى حقله، إلى زمن الإثم الصهيوني، الذي يمزّق كيان الفلاح وهو يمزق أرضه، ويسيجّهما بأسلاك شائكة. كأن الصهيوني المنتصر خالق جديد للقدر الفلسطيني كله، يحدّد المسموح والممنوع ويلغي الأسماء القديمة بأسماء جديدة، قبل أن يقرّر إعدام من يشاء والعفو عمّن يشاء أيضاً. ويكشف العمل، على مستوى الرؤية، الانتقال من »التاريخ العام« إلى تجلّياته الإنسانية المشخصة، التي تعلن عن جدل الكذب والانتصار، ذلك أن الصهيوني يقول شيئاً ويفعل آخر، تاركاً للفلسطينيين فضائل القهر والحرمان والبوح الحزين. ولهذا يصور قيس شكاوى الفلسطينيين التي تتصادى بين الذاكرة الحزينة والأسلاك والأرض المختلسة، وتتجمّع في عجوز ذابلة العينين تحتضن صورتي ولديها الشهيدين، ويصوّر، في تزامن يترجم الحقيقة، صهيونيين يقفون في فضاء مغاير، يخلطون الكلام بالانتصار، والكلام المنتصر بدعاوى زائفة. وما الكذب، الذي تصطاده الكاميرا وتعلّق عليه، إلا الفرق بين حقول فلسطينية مبتورة ومسيجة وبنايات شاهقة تربض فوق حقول قتيلة كثيرة، وكلام عن »مكان للجميع« تغطيه الطائرات وتعتقله الدبابات والأوامر العسكرية.
حين يتلفظ الإسرائيلي بجملة: »نحن لا نطرد أحداً وهناك مكان للجميع«، تردّ عليه الكاميرا – الوثيقة بما يكشف عن زيف كلامه، كاشفة عن وعيد الطيران والمدافع، ثم خطاب مناحيم بيغن، المأخوذ بـ»نقاء أرض الميعاد«، فمكبرات الصوت وخطر التجوّل والقمع والسجن، وتلك الأسلاك الشائكة التي تحاصر الأرض والإنسان والحقيقة. يترك قيس الفلسطيني مع وجه حزين، ينعي »حقوق الإنسان« الشهيرة، ويوكل إلى »الأرشيف السينمائي« الدفاع عن الفلسطيني المستلب، حيث »الوثيقة« تنصر القول الفلسطيني وتتهم الكذب بالمطمئن إلى إيديولوجيا الانتصار. تتحول الوثيقة السينمائية إلى محام نزيه لا صوت له، إلا من آهة الفلسطيني التي لا تنتهي، وأصوات المجنزرات الإسرائيلية التي تغتصب الأشجار وطيّات الذكريات.

تغدو »الأسلاك الشائكة«، في فيلم قيس الزبيدي، مجازاً متعدد الأبعاد، فهي عنوان المسموح والممنوع وما كان وما صار والحد الفاصل بين ملكية شرعية وأخرى مغتصبة، وهي الموقع الجارح الدامي الذي يستدعي العقاب. لكن قيس في فيلمه »يوميات مجزرة«، عن أحداث صبرا وشاتيلا 1982، يستغني عن مجازه السابق، ويدخل إلى المأساة المتجددة من مجاز آخر أشد وضوحاً، وأشد رعباً في وضوحه المروّع، فالمشهد كله للجثث المكوّمة على أبواب البيوت وفي الحواري الضيقة، والمشهد كله للموت القاسي الذي يحوّم فوق أزمنة الفلسطينيين وأمكنتهم. »مَنْ يبحث عن الحقيقة يموت في الطريق«، يقال. والفلسطينيون يُقتلون وهم يبحثون عن حقيقة الوطن، ويُتركون عراة مع موتهم القاسي، كي يكفّوا عن البحث ويهربون، لاحقاً، من طلقات قاتل متعدد اللغات. ولهذا يرسم قيس المشهد الكابوسي ويعلّق عليه مستقدماً الوثيقة – البرهان، التي تشهد على مناحيم بيغن متحدثاً عن »استئصال الإرهاب الأخير«، وعلى شيمعون بيرس متكلماً عن الأمن وشروطه، إلى أن ترتد إلى مسؤول محلي يعد بـ»طرد جميع الغرباء«.

وطن الاسلاك الشائكة
يقتفي قيس، متكئ على الوثيقة، آثار المجزرة، وينتج من الصور المتلاحقة خطاباً، يشرح معنى »الإرهاب« في الفكر الإرهابي، الذي يستولد »الأمن النهائي« من »حل نهائي«، يقتل الفلسطينيين جميعاً في مخيم أعزل، إلا من الذكريات وصور الشهداء، ويؤسس »الدولة المستقلة« على رفات الذين لا وطن لهم. يترافد كلام »الأمن« مع كلام »السيادة«، ويتحولان إلى رصاص يبعثر آلاف الجثث في اتجاهات مختلفة، كما لو كانت جثة الفلسطيني شرطاً لازماً للسيادة والأمان. يبدأ قيس من المجزرة الشهيرة، وتعثر الوثائق على مجرمين، يتحدثون بلغات مختلفة، وتصوغ الصور المتلاحقة سؤالها الكبير: إلى أين يذهب فلسطينيون لا يعترف بوجودهم أحد؟ والجواب قائم في السؤال: يذهبون إلى موت غريب يساوي وجودهم الغريب. ولهذا لن يلتقي الفلسطينيون بقبورهم المنتظرة، فمقابرهم الجماعية نتيجة لتقتيلهم الجماعي. بل أن قيس، الذي يحوّل الوثيقة إلى شاهد نزيه ومحامي دفاع لا يقل نزاهة، يرى في المجزرة الكبيرة مرآة لمجازر سابقة وأخرى لاحقة، فقد سبقها خطاب بيغن، الواعد بـ»سلام نهائي«، وأعقبها دوّي الغارات والقنابل المتساقطة على المخيمات. كأن هذا الفنان العراقي، الذي يعيش الفن ولا يعتاش منه، يشتق المجزرة من طقوس الذبح المقدس المتمردة، التي تحايث إيديولوجيا عنصرية، ترى سلام الإسرائيليين في تذبيح الفلسطينيين، وترى سلام الفلسطينيين في الذهاب إلى المقبرة. لا غرابة، إذن، في ذلك التلازم العجيب بين صعود خطاب السلام واتساع المذابح الفلسطينية، فبعد كل مجزرة كبيرة يأتي حديث عن السلام و»حقوق الفلسطينيين«، يسقط، لاحقاً، في النسيان، في انتظار مذبحة جديدة توقظ »كلاماً سلامياً« من نوع مختلف.
دخل قيس الزبيدي إلى موضوعه الفلسطيني من جهات مختلفة، قاصداً بذلك أمرين: أولهما تجديد »الفيلم الفلسطيني«، المقيد أبداً إلى مادة تاريخية، تراجيدية المعنى وخطيّة المسار. فهذا »الفيلم الساكن«، الذي أدمنت عليه، ولفترة طويلة، المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، يبدأ بـ»وعد بلفور« وينتهي إلى المخيمات الفلسطينية، التي تجاوز الستين مخيماً، بعد أن يتوقف أمام الإرهاب الصهيوني، وعنوانه الأكبر »مجزرة دير ياسين«. عمل قيس على تجديد الفيلم الوثائقي وكسر خطيّته الرتيبة، معتمداً تجديد وإغناء المادة الوثائقية وتنويع المواضيع والرؤى، التي تتوزّع على المؤرخ والطفل والمرأة ورجل الحياة العادية، والمزج بين »الوثائقي« و»التسجيلي«.. ويتمثل ثاني الأمرين في امتلاك جوهر الموضوع الفلسطيني عن طريق الذهاب إليه من جهات مختلفة، لأن »معنى الحقيقة« يصدر عن الدروب المتعددة التي تفضي إليها. وبهذا المعنى، لا يكون قيس الزبيدي فقط مؤرخاً فلسطينياً نوعياً بامتياز، بقدر ما يكون أيضاً المرجع السينمائي الأول في تأريخ القضية الفلسطينية، على مستوى المادة والأدوات والمنظور في آن. فإذا كان الفيلم التسجيلي الفلسطيني، ولفترة طويلة، فيلماً واحداً، في أشكاله المختلفة، فقد انتقل به قيس من صيغة المفرد الساكن إلى صيغة المتعدد التي لا تعرف السكون. وربما يمثّل قيس، في تعامله السينمائي مع القضية الفلسطينية، حالة شبه فريدة في ديالكتيك الإبداع والموضوع المقيّد، الذي يجعل المبدع يوسّع موضوعه بوسائل إبداعية، ويحرّره من قيوده بأدوات فنية مختلفة.
وعى الزبيدي، مبكراً، مفارقة الفيلم التسجيلي الفلسطيني، الذي يختزل مأساة إنسانية واسعة الوجوه والاتجاهات إلى مادة وثائقية ضيّقة وحيدة الرؤية، واستولد أدوات تقرّب بين معنى المأساة وتسجيلها السينمائي. وعن هذا الوعي، الذي يكشف عن رهافة الفنان وهو يكتشف معنى موضوعه، جاء دور الطفل الفلسطيني في الشهادة على مأساة شعبه، كما لو كان الطفل هو الهامش البعيد الذي يجلو معنى المركز الذي ينتسب إليه، أو شظية من مرآة تحتضن مبنى الموضوع المأساوي كله ومعناه. وما فيلمه »الأطفال الفلسطينيون في زمن الحرب«، الذي أعقب خروج المقاومة من بيروت، إلا صورة عن جدل المركز الفلسطيني وهامشه، حيث الطفل اللاجئ هو الموضوع والسارد والشاهد معاً. ففي هذا الفيلم، الذي لا شعارات فيه، يسرد الطفل مأساة شعبه مرتين: مرة أولى بأحواله الحزينة القائمة في زمان ومكان لا ينقصهما الحزن، ومرة ثانية بسرده الحزين، الذي يتكثّف في رسوم بريئة، تنطق بالرعب والحزن والحرمان. كل رسم طفولي يكمل رسماً آخر، ولوحات الأطفال جميعاً تقص مصائر آبائهم. يحكي بؤس الطفل عن بؤس أبيه الذي كان طفلاً بائساً بدوره، وتترجم ألوان الأطفال معنى الواقع الذي يعيشه الأطفال، كأن حقيقة الأب من حقيقة الطفل الذي كانه، التي تستمر في طفولة حزينة لا طفولة فيها، بقدر ما أن حقيقة الواقع المرعب من حقيقة الألوان التي تحيل عليه، أحمر وأسود وفراغ قلق يصل بينهما، أحمر وأسود وسلاح إسرائيلي يمحو الطفولة الفلسطينية، ويستبقي منها آثاراً، تحتج على الوجود والألوان معاً.
السارد – الطفل هو مركز فيلم آخر عنوانه: »بعيداً عن الوطن«، حيث يولد المعنى الفلسطيني من سرد متناوب على لسان الأطفال. يُستكمل معنى »المساحة اللونية« في الفيلم السابق، بمساحة أخرى، فلكل طفل موضوعه وألوانه وحكايته، بينما يبدو الأطفال في هذا الفيلم هم اللون والموضوع والحكاية، يتكاملون في ألوانهم ويتعدّدون في مواضيعهم وتوحدهم حكاية واحدة كبيرة وقاسية. وكعادته، سواء كانت المادة التوثيقية ضيّقة أم واسعة، فإن قيس ينتج من موضوعه خطاباً خاصاً به، يجمع القول المتناثر في صيغة واضحة. فالأطفال الذين لا وطن لهم أطفال بلا طفولة، فلا طفولة لطفل اغتيلت شروط طفولته، بل أنهم أطفال كهول، يعرفون آثار الدمار ويجهلون لعب الطفولة السوية، ويتخذون من الآثار القاتلة لعباً وحكايات ودروباً تفضي إلى الموت الحقيقي أو الرمزي. في استنطاقه أطفال بلا طفولة، يتكشّف قيس الزبيدي فناناً وأخلاقياً كبيراً وشاهداً على تداعي القيم الإنسانية ومدافعاً نبيلاً عن حق الإنسان في حياة سويّة.
»كي تنفذ إلى حقيقة الموضوع الذي تعالجه، عليك أن تنفذ إليه من جهات مختلفة«، هذا ما يعلنه قيس الزبيدي ممارسةً، وما يفعله محاوراً الوجع الفلسطيني من نوافذ مختلفة. وهذه الرؤية، التي جاء بها شغف الحقيقة لا تعاليم الكتب، هي التي قادته، في بداية التسعينيات الماضية، إلى أن ينجز فيلماً عن المحامية »فيليسيا لانغر«، التي أجبرتها العنصرية الصهيونية على الرحيل عن إسرائيل إلى ألمانيا، بسبب دفاعها النزيه عن المعتقلين الفلسطينيين. فبعد مجاز الأسلاك الشائكة والمجزرة وخطاب المؤرخ والسارد – الطفل، تأتي الحقيقة الفلسطينية من مسار محامية يهودية، تحب الحقيقة أكثر مما تحب إسرائيل، وتدافع عن الحقيقة التي لا يقبل بها العنصريون، إلى أن تودّع الفلسطينيين، الذين دافعت عنهم، وتحمل معها حقيقتها ذاهبة إلى مكان آخر.
في هذا الفيلم، الذي يرصد شخصية لانجر من زوايا مختلفة، يصل قيس، على مستوى الرؤية، إلى أكثر أفلامه وضوحاً وتكاملاً واتساعاً. فهو يبدأ ممّا يكمل توثيقه للمأساة الفلسطينية، أو للإرهاب الصهيوني الذي أنتجها، متخذاً من فيليسيا لانغر، الأخلاقية الفاتنة، مرجعاً، يضيء معنى إسرائيل من وجهة نظر يهودية – إسرائيلية، بل من وجهة نظر إنسانية رحيبة تفيض على المراجع الجغرافية والسياسية والدينية، تستنكر القمع وتدافع عن معنى القانون الموضوعي وتنحاز إلى حقيقة نقية مبرأة من التعصب والمراتب البشرية. غير أن قيس، الذي يعرف الماركسية ولا يعترف بـ»البطل الإيجابي«، يشتق من المناضل من أجل العدل حقيقته الإنسانية الرحبة، ملقياً ضوءاً جميلاً على فيليسيا الأم والزوجة والمحامية والمثقفة والخطيبة، والشخصية النوعية التي يتوّج الأخلاقيون مسارها بأكثر من تكريم. ولعل هذا المنظور الإنساني العميق هو الذي فرض الجمال فضاء إشارياً واسعاً، يحف بالمحامية العادلة وينطق بجوهرها الداخلي. يواجه قيس قبح الكراهية بجمالية الحب وسديم العنصرية بجمالية الشكل، كما لو كان الشكل الواضح المتميّز معيار الارتقاء والحقيقة والجمال. فبقدر ما ينقض التسامح العنصرية المغلقة، ينقض الفن المجازر والظلم والسجون، ويطالب بعالم بديل يبني القيم الراقية ويمارسها معاً.
سار قيس الزبيدي، في أفلامه المتعاقبة، مع القضية الفلسطينية، منذ بداياتها الأولى إلى نهاياتها الراهنة، التي لا تنتهي، خالقاً ذاكرة فلسطينية واسعة، تتضمن أشياء من النصر وأشياء كثيرة من الهزائم والأوجاع والكوابيس. وكان في سعيه، الجدير بالتكريم، يوثّق للفلسطينيين ذاكرتهم المضادة، أي الذاكرة الصهيونية، التي تملي على الذاكرة الفلسطينية أحلامها وكوابيسها أيضاً، وذلك في تناقض مأساوي رهيب، يعيّن الحلم الفلسطيني كابوساً إسرائيلياً ويؤكد الحلم الإسرائيلي كابوساً فلسطينياً. غير أن قيس، وهو يتأمل الذاكرتين معاً، كان يبني ذاكرته الفنية، التي خلقت منه مؤرخاً خاصاً، يؤرخ بالوثيقة والصورة والألوان والوجوه، مؤرخاً مرجعاً، خلق تجربته وينقل التجربة إلى الآخرين. ربما كان في شخصية قيس – الفنان بعض الأشياء من شخصية المحامية الأخلاقية »لانجر«، التي بنى مسارها من وثائق متنوعة متعددة، وربما هذا التشابه، المشدود إلى الخير والدفاع عنه، هو الذي أتاح للفنان العراقي أن يعطي عملاً مؤثراً، يبني عالمه الجميل من عناصر جميلة أيضاً.

قيس الزبيدي.. عراقي صنع بعدسته فلسطين أخرى أبعد من الخيال
تعدّدية العناصر وكسر النموذج الجاهز:
يعاند قيس، في أفلامه الفلسطينية، المادة الوثائقية ويروضّها معاً: يعاند محدوديتها، وهو يرفض الخضوع إلى المادة التي وجدها، ويتمرد على سلطتها، حين تملي عليه ما أملته على غيره. ففي المادة الوثائقية الفلسطينية، المصاغة من التهجير والسجون وبؤس المخيمات، ما يقيّد حركة الفنان ويحاصر تصوره، كما لو كان المأساوي الفلسطيني يسيطر على غيره ولا يُسيْطَر عليه. غير أن قيس، الذي يعيد صياغة المأساوي، يسيطر على المادة الضاغطة، مؤكداً ذاتية فنية مستقلة، ويبرهن عن وحدة الذاتية المستقلة والمنظور الفني. لذا، فإنه يقدّم المادة الوثائقية، كما يراها، حيزاً للإيحاء والإيضاح والمساءلة، قبل أن تكون شريطاً من الصور المتواترة.
رفض قيس، منذ البداية، الفيلم الدعائي النمطي، الذي يُختزل إلى أفكار مباشرة خارجية، ويختصر الأفلام المتعددة إلى فيلم واحد واضح البداية والنهاية. فمعظم الأفلام الوثائقية الفلسطينية لم تكن أكثر من تعليق سياسي جاهز على شريط من الصور الجاهزة أيضاً، بل أن العقلية الإعلامية المسيطرة كانت تطالب بهذا وتحضّ عليه، بحثاً عن »الشفافية« والوضوح التربوي. أنجز قيس، وبأشكال متفاوتة، فيلماً آخر، يرفض المطابقة بين عنصرين بسيطين هما: الصورة والتعليق، ويسعى إلى إنتاج المعنى من عناصر فنية متعددة. وكان في ما يفعل يعبّر عن حرية الفنان، فلا حرية إلا بالمتعدد ولا عمل فني إلا بالعناصر المتنوعة التي تندرج فيه، ويفصل بين المقاربة الفنية والقول السياسي، فالأولى متعددة الدلالة والثاني أحادي المعنى. وواقع الأمر، أن الزبيدي، المشغول بتكثير عناصر عمله الفني، يشتق معنى الفن من الإنسان الحي لا من الوثيقة التي تصوره، ومن التباس الحياة المتدفقة لا من الثنائيات الجاهزة، التي تتحدث عن الخير والشر أو عن النصر والهزيمة. وبسبب ذلك، صوّر القضية الفلسطينية وهو يصوّر المؤرخ والسياسي والفلاح والطفل والمرأة، وصوّرها وهو يرى إلى السهل الفسيح والأسلاك الشائكة وقبر الشهيد والقصيدة وصوت الناي الحزين. وبسبب ذلك أيضاً ذهب إلى اكثر من إسرائيلي، رافضاً فكرة »الجوهر اليهودي«، التي تحوّل اليهود إلى كتلة متجانسة، دورها اقتلاع الفلسطينيين وإهلاكهم.
يعلن قيس الزبيدي، وهو يخلق فيلماً متعدد العناصر، عن مرونة الحياة وقلق الفنان وتمرد العمل الفني على الاختصار والأفكار القاطعة. وفيلمه »شهادة الأطفال في زمن الحرب«، يقدّم مثالاً على عمل فني تصوغه الصورة الفوتوغرافية »الساكنة« والشهادات الحية والمساحات اللونية والسرد الطفولي، وإيقاع موسيقي حزين، يصرّح بطفولة مغتالة أو قيد الاغتيال. تستولد العناصر المتعددة من علاقاتها المتبادلة حواراً داخلياً، يضيف إلى العناصر المرئية أخرى محتجبة، ويضع في المعنى الظاهري معنى آخر، هو المعنى الفني، الذي يضع في المرئي والملموس والمحسوس »شيئاً آخر«. وهذا الشيء الآخر، الذي يميّز العمل الفني من »موضوعه الخارجي«، أثرٌ للحوار بين عناصر العمل المتعددة. فحوار الموسيقا مع صورة الطفل الحزين يخلق صورة جديدة، تشير إلى الفرق بين واقع الطفل المغترب وواقع آخر يعيش الطفل فيه حياته السويّة، مثلما أن تعارض الألوان، في رسوم الأطفال، ينتج لوناً جديداً تطفو فوقه صور الأطفال التعساء جميعاً. كأن في الطفل ما يحاور شقاءه، وفي الرسوم رسوماً أخرى غير منظورة، وفي لقاء اللون مع الموسيقى ما يحضّ المتفرج على الحوار مع ذاته. ينجز قيس، وفي لقطات سريعة، مشهداً مأساوياً، يحتضن الحزن الفلسطيني ويفيض عليه.
وربما يكون فيلم »الزيارة«، وهو قصير جداً، النموذج الفني الذي هجس به قيس طويلاً، ولا يزال. ففي هذا الفيلم يظهر الواقع الفلسطيني ويظهر، أولاً، ما »يضيفه« الفن إلى الواقع، وهو يتوسل عناصر متعددة، تعيد خلق الواقع وتكثّفه، وصولاً إلى واقع فني كثيف، يتضمن الواقع المعايش وواقعاً آخر، بصيغة الجمع. فهذا العمل، الذي يقوم على واقعة بسيطة قوامها »الاعتقال«، يستنفر من العناصر الفنية ما يبني به »الاعتقال في ذاته«، مسّ الفلسطينيين أم مسّ غيرهم، وما يجسّد جدل القهر والمقاومة في فلسطين وخارجها. بل أن في هذا الفيلم، الذي يفصح عن وحدة الفن والحرية، ما يقبل بصفة القهر الفلسطيني ويمنعها، ذلك أن قيس، وفي تجريد فني محدّد، أعطى عملاً يتمرد على المكان والزمان، يعيّن ذاته عملاً إنسانياً شاملاً بامتياز. صدر الأثر عن تعددية فنية مدهشة، تنطوي على القصيدة واللون والموسيقا والرسم والتمثيل البديع، وذلك الفضاء الإبداعي الذي يضع الفنان فيه العناصر جميعاً. لم يصدر الأثر الفني، بهذا المعنى، عن تراصف العناصر بل عن تحوّلها إلى وحدة منسجمة متعددة الوجوه. في هذا الفيلم القصير، دَرْسٌ نجيب في السرد الشعري السينمائي، ودرس آخر في تكامل الفنون، ذلك أن قيس حاور قصائد فلسطينية، وانتهى إلى قصيدة خاصة به. بدأ من قصائد – وثيقة، وأعاد كتابتها باللون والصوت والحركة والتقطيع، منتهياً إلى قصيدة جديدة، أكثر من الأولى كثافة وجمالاً وأثراً. وإذا كان غيره، قد اكتفى بإعادة إنتاج »الوثيقة الأولى«، أو الوثيقة الأوليّة، فإن قيس، الذي يتكئ على ذاته المستقلة وهو يتعامل مع الوثيقة، أنتج وثيقة، تحيل على وثائق أخرى وتبدو مفردة مستقلة. كيفَ تكتب قصيدة بلغة السينما لا بلغة الشعر المألوفة؟ هذا هو سؤال فيلم »الزيارة«، الذي أجاب عليه قيس الزبيدي مبدعاً، مصرّحاً بأن الفن يدافع عن الحرية حين يكون فناً حراً، والفن الحر يحرّر الزمن مكانه ويحرّر الوثيقة من معناها الظاهري.
يعرّف قيس، في ممارسته، الخلق الفني، مبيّناً أن الخلق، في معناه الحقيقي، إعادة تركيب لما هو موجود، مبتعداً عن شكلانية ثرثارة، تشتق الجمال من الجمال والمعنى من مساحات فارغة. ولعل الركون إلى خلقٍ فني، يعيد تركيب العناصر المعطاة بشكل مختلف، هو الذي يجعل من »بداية الفيلم« مدخلاً لقراءته، إن صح القول، لا بمعنى البداية التي تعيد إنتاج ذاتها، بل بمعنى البداية التي تنظّم القول الذي يتلوها. لذلك، تأخذ البداية، في فيلم الزبيدي، أهمية خاصة. يبدأ »وطن الأسلاك الشائكة«، على سبيل المثال، بتعارض متمهّل بين المقيّد والطليق والعدواني والمسالم، أي بتعارض بين الفلاح الفلسطيني والجندي الإسرائيلي. فبعد الدبابة والجنود المستنفرين، اللذين يُعطف عليهما خطاب بيغن الإرهابي، تأتي الأرض الفسيحة الهادئة، كما لو كانت الحقول الفلسطينية، التي كانت طليقة ذات مرة، تحتج في وداعتها المترامية على الأسلاك الشائكة. تأتي الأرض، في مشهد بطيء متمهّل، يقف فوقها فلاح واحد، لا يلبث أن يتكاثر إلى جمع من الفلاحين، قبل أن تظهر الأسلاك التي تقيّد الأرض والفلاح معاً. يعطي قيس المشهد ثم يقلبه، مذكراً بجدل الأطروحة والطباق كي يصل، لاحقاً، إلى تركيب ضروري، يطالب بتحرير المعتقل وإطلاق المقيد. ولن يكون الأمر مختلفاً في بداية فيلم »المواجهة«، الذي يسرد حصار بيروت اجتياح إسرائيل للبنان عام 1982. ففي الصورة الأولى ما يذكّر بتناقض الطهر والدنس، الذي تترجمه سماء زرقاء تخترقها طائرة حربية توزّع الموت. تحيل الطائرة على صناعة الموت، بقدر ما تشرف السماء على سيارات الإسعاف والأوصال المقطعة، وقضية عادلة لا تنقصها البراءة. وبداية »شهادة الأطفال في زمن الحرب« مدخل نموذجي لقراءة تفاصيل الفيلم اللاحقة. فبعد الوجوه التي لا تشبه الوجوه والظلال المعتمة والأفواه المغلقة، تأتي الألوان الصارخة المتعارضة، موحية بأن ما لا يعبّر عنه الطفل كلاماً، ولا يستطيع التعبير عنه على أية حال، يعبّر عنه اللون، تلك اللغة الغامضة التي تبوح بها الروح عن أسرارها المعقدة، وتسرد بها الذاكرة كوابيسها الخانقة. بل أن الاقتصاد الإشاري الدال، والمدهش في دلالته المكثفة، يجعل من بداية الفيلم الأخير فيلماً مكتفياً بذاته، تاركاً ما تبقى تفاصيل توسّع معنى المدخل الكبير.
أخبر قيس الزبيدي عن حسه الفني الرهيف، وهو يوسع مادة ضيقة، وأعلن عن الفنان الكبير الذي فيه، وهو يشتق من المادة الضيقة إشارات فنية، تحوّل الضيق المحدود إلى مادة إنسانية – فنية شاسعة. كان في الحالين، يبرهن أن سر الفن يقوم في الفنان، لا في المادة التي يتعامل معها.
