”الموت والعذراء“ (*)
تأليف أرييل دورفمان
ترجمة : علي كامل
أهمية هذه المسرحية هي أن موضوعها يتماهى مع ما حدث في العراق عام ٢٠٠٣ أي (سقوط الدكتاتور في شيلي يقابله سقوط صدام في العراق وقيام حكومة ديموقراطية في شيلي يفترض أن يقابلها ذات الشيء في العراق.. ولكن…)..
شيء آخر، المسرحية تم تحويلها إلى فيلم سينمائي بنفس العنوان أخرجه رومان بولانسكي مؤكد أنك شاهدته.
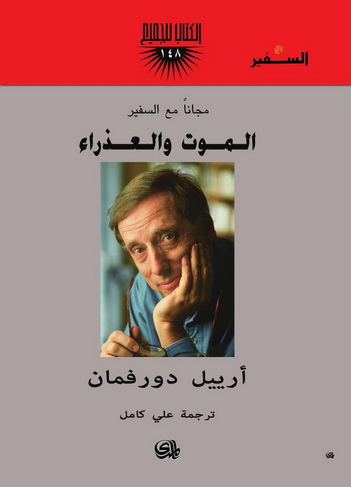
”الموت والعذراء“ (*)
تأليف أرييل دورفمان ترجمة وتقديم علي كامل
مقدمة المترجم
“أنا ذلكَ الكذاَّب الذي يقولُ الحقيقةَ دائماً“
جان كوكتو
لم تستطع سنواتُ المنفى الثقيلة والخانقة أن تُثبط آماله الكبيرة ولا المكانُ أن يطمس هُويتَّه، فقد قرَّر لحظة وصوله أمريكا، لاجئاً، أن يجعل من كتاباته سلاحاً، ومن غُرفة مكتبه الصغير، ورشةُ عملٍ يومي وساحةِ حربٍ ضدَّ من شرّدوه، من خنقوا صوت الحرية في بلاده، وضدَّ وحشية الاستبداد وبربريَّته في كل مكان.
كان أرييل دورفمان يُعلّقُ صورة مواطنه بابلو نيرودا على أحد جدارن غرفة مكتبه المُعتم لتُضيء له وحشةُ سنوات الاغتراب، وبالقرب منها كتب بخط يده عبارة، كان قد استعارها من أحد معارفه القدامى، وهو الروائي الأرجنتيني “هارولد كونتي” سلفه في المنافي، تقول العبارة: “هنا ساحة الحرب، ساحة معركتي، ولن أغادرهاً أبداً”.
(لا بّد لأحدٍ ما أن يبقى حيّاً ليروي ما حدثْ)
كان أرييل دورفمان يشغل موقع بروفيسور محاضر لمادة الأدب والنقد في جامعة شيلي، وكان قد رُشّح في عام 1971 ليكون مستشاراً ثقافياً ضمن هيئة المستشارين الخصوصيين للرئيس أليندي في قصر لامُونيدا، إلا أن الانقلاب الدمويّ على حكومة سلفادور أليندي الذي جرى في الحادي عشر من سبتمبر عام 1973 سيغيّر مجرى حياته تماماً، فقد تمَّ تصفية الكثير من أصدقائه ورفاقه في ذلك الصباح المفجع، ساعة اقتحام قوات بينوشيه قصرَ لامُونيدا، إلا أن أرييل نجا ذلك اليوم من موت مّحتَّم بأعجوبة! .
في المقابلة التي أجراها معه داني بوستل في مجلة The Progressive الأميركية عام 1998 قال دورفمان:
(… كان عليَّ أن أكون في قصر لامونيدا في ذلك اليوم الفاجع. كانت هناك قائمة بأسماء الأشخاص الذين ينبغي تواجدهم في الأحداث أو الأوقات الطارئة وكان اسمي واحداً من ضمن تلك الأسماء، لكنَّ أحداً لم يتصل بي ذلك اليوم وتركوني أستمتع بنومي ذلك الصباح.
لم أفهم السبب مطلقاً بالطبع، إلا إنني، بعد ثلاث سنوات، وبطريق الصدفة، قابلت الشخص الذي كان مسؤولاً عن تنظيم تلك القائمة آنذاك واسمه فرناندو فلوريس، وفي ذلك اللقاء فقط عرفت سر بقائي حياً. فقد أخبرني أنه كان قد شطب اسمي من قائمة المناوبة تلك في ذلك الصباح، وحينما سألته عن السبب، صمت قليلاً وغار عميقاً، كما لو أنه أراد إن يسترجع تلك اللحظات
المرعبة ثانية. أخيراً، تطّلع نحوي قائلاً: “حسناً… كان لابدَّ لأحدٍ ما أن يبقى حياً ليروي ما حدث”.
لم تكن ثمة معجزة دينية وراء بقائي حيّاً، ولا أُؤمن بأن هناك قوى غيبية هي التي أنقذتني من ذلك الموت المحتَّم. لكنني موقن بشيء اسمه قدر الإنسان، أو ذلك الشيء الذي يُحيل الأحداث التي تمر في حياة الإنسان إلى شيء ضروري لابدَّ من وقوعه.
ما فعلته أنا، حسب ظني، هو أنني أحلت نفسي إلى راوي حكايات. وهكذا أمضيتُ الخمسة والعشرين عاماً الأخيرة أروي قصَّة شيلي بطرق مختلفة.
إِن الكثير من كتاباتي تتحَّدث عن إنسان تنتابه فكرة ما تلازمه على نحو دائم، وهي أَنه يعيش مثل شبح، وأن كلَّ شيء ما هو إلا مجرَّد وهْم، وأَن ثمة أُناس يموتون من أجل أن نبقى نحن على قيد الحياة، فلزاماً علينا أن نُقدِّم لهم شيئاً ما. كيف بوسعنا فعل ذلك؟ كيف يُمكننا أن نتحدَّث إليهم، نحكي قصصُهم، ومن أجلِهم، بل وعلى الرغم منهم؟ ومع ذلك، فإِن قصصي ليست قصصاً عن الموت فقط. كلا، إنها تتحدث عن الحياة والتَّغني بها أيضاً)
***
استوحى الكاتب عنوان مسرحيته “الموت والعذراء” من رباعية شُوبرت الوتريَّة التي تحمل ذات العنوان، وهي قصيدة مُغناَّة من تأليف ماتياس كلاوديوس (1740 ـ 1815). أما الثيمة فقد استقاها من خبر كان قرأه في صحيفة تشيلية، يحكي قصة رجل أنقذ حياة شخص انقلبت عربته في الطريق العام وكادت تودي بحياته، وأثناء دعوة الرجل لذلك الغريب ضيفاً إلى منزله، تحدث المفاجئة المروعة. الزوجة المفعمة بالخوف والمحاصرة بالرعب الخفي الذي تتقاسمه فقط مع الرجل الذي تُحب والتي يتعين
عليها مواجهة ذلك الخوف طوال الليل والنهار، ستطبق العدالة في منزلها، في غرفة جلوسها، بحق الضيف الذي تعتقده هو المسؤول عن تعذيبها واغتصابها منذ سنوات مضت.
يقول دورفمان: “.. لقد تأمَّلتُ تلك الحادثة عميقاً وبدأتُ أستكشفُ في مخيّلتي، بشكل خجلٍ ومترّدد، حالةٌ دراماتيكية أصبحتْ فيما بعد نواة لمسرحية (الموت والعذراء)، وهي إنًّ الزوجة المفعمة بالخوف والمحاصرة بالرعب الخفي الذي تتقاسمه فقط
مع الرجل الذي تُحب والتي يتعين عليها مواجهة ذلك الخوف طوال الليل والنهار، ستطبق العدالة في منزلها، في غرفة جلوسها، بحق الضيف الذي تعتقده هو المسؤول عن تعذيبها واغتصابها منذ سنوات مضت.
كنت أجلس بين الحين والآخر أُفكّر بهذا الموضوع وأخربش على الورق ما تخيَّلْتهُ أن يكون في يوم ما رواية. لكن، بعد جلسات عدَّة وبضع صفحاتٍ غير مقنعة، تراجعتُ خائباً عن تلك الفكرة كُلّها تماماً، بسبب أنَّ ثمَّة شيئاً ما كان غائماً، شيئاً جوهرياً وضروريّاً في الحكاية كان مفقوداً. فمثلاً، لم أستطعْ أن أستكشفَ جوهرُ شخصيَّة زوج تلك المرأة. تُرى من هو؟ وكيف ستكون استجابته إن صّدقها؟
لم تكن الوقائع والظروف والالتباسات التفصيلية التي ظهرت من خلالها تلك الحكاية جلية عندي أيضاً. كذلك ثمة غياب للعلاقات الرمزية والدلالية بين العام والخاص. أعني بالتحديد، ما نوع علاقة هذه الحكاية بالوضع العام للحياة في البلاد.
الأمر الآخر الذي لم أفهمه جيداً هو صورة العالَم الذي كان يقف خلف تلك الحدود الضيقة والخانقة والمغلقة لمنزل تلك المرأة!”.
هكذا ولسوء الحظّ ظلَّت المسرحية تنتظر، مكرهةً، مثل دورفمان نفسه، لوقت طويل، لحين زوال النظام الديكتاتوري في البلاد عام 1990 وعودة الكاتب وعائلته إلى تشيلي بعد نفيٍ استغرق سبعة عشر عاماً. وفي زحمة الأحداث السياسية الجديدة والشائكة عثر الكاتب على إجاباتٍ لتلك الأسئلة التي كانت غائمة في ذهنه آنذاك واستطاع أن يُمسك بالخيط الذي قاده أخيراً إلى الطريقة التي ستُروى بها تلك الحكاية.
(ديموقراطيات في دور النقاهة)
لابدَّ من إلقاء الضوء على الخلفية السياسية لهذه الثيمة لأنها ستمنح الكاتب المفتاح الرئيسي لحل مغاليق الحكاية والتي ستُجيب عن تلك الأسئلة التي كانت اجاباتها مبهمة في رأسه.
كان الوضع السياسي في تشيلي إبَّان زوال نظام بينوشيه الفاشي وقيام السُّلطة الوطنية المُنتخبة يُنذر باحتمال وقوع حرب أهلية
في البلاد بسبب الإجراءات المؤقَّتة التي اتخذتها الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها الإبقاء على الكثير من رموز النظام السَّابق في مواقع خطيرة وحسَّاسة، كالمؤسسة القضائية ومجلس النواب والمجالس البلديَّة وكذلك المؤسَّسات الاقتصادية، فضلاً عن ترك الكثير من أزلام السلطة من العسكر ورجال الأمن والمخابرات طليقين دون عقاب.
كان ذلك الإجراء قد أثار ضغينة النَّاس وغضبهم بالطَّبع، لا سيما أولئك الذين ظلَّ يسكن قلوبهم الهلع رغم سقوط الدكتاتور، والذين أحا لتهم زنازين الدكتاتوريَّة الى مجرَّد أشباح، أو أنصاف بشر. فتلك الإجراءات المؤقَّتة قد أثارت فيهم حقاً مخاوف عودة النظام القديم الى السُّلطة ثانية. واقع الأمر، إنّ الرئيس الجديد المُنتخب (باتريسيو ايلوين) كان يسعى من خلال تلك الإجراءات إلى تطبيق برنامج إصلاحي براغماتي للبلاد ووضع حلولٍ وسطيَّة بشأن التعامل مع أدوات النظام القديم خشية من تجدُّد الوضع الإرهابي ثانية تحت غطاء الديموقراطيَّة هذه المرة، وخوفاً من قيام مذابح جديدة وعمليات ثأر شخصية، ربما تقود فعلاً إلى حرب أهليَّة وإلى فوضى قد تفقد البلاد فرصتها التاريخيَّة تلك وتُفضي إلى عودة النظام الديكتاتوري ثانية الى البلاد.
هكذا، ولأجل تطبيق ذلك البرنامج، قامت السُّلطة بتشكيل هيئة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان هدفها التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في زمن الدكتاتور بينوشيه، سميت بـ “هيئة ريتيج”، والتي كانت تُصدر عقوبات بالموت أو احتماله، شرط ألا يُعلَن عن أسماء المجرمين أو تُجرى محاكمتهم علناً.
علق دورفمان حينها قائلاً: “لقد استطاع الرئيس إيلوين حقاً أن يُدير الدفَّة بحذر وشجاعة وتبصر بإتباعه مسلكاً وسطاً يُوّفقُ ما بين أُولئك الذين يؤْثِرون دفن خوف الماضي الإرهابي كُليّاً وأُولئك الذين يريدون الكشف عنه كاملاً”.
كإجراء احترازيّ، قامت تلك اللَّجنة حينها، بحجب أسماء أولئك المُتّهمين وعدم استدعاؤُهم لحضور تلك المحاكم علناً، خشية وقوع صدامات دمويَّة بين عائلاتهم وأهالي المُتّهمين. إلا أن المأزق الأكبر هو أن تلك العدالة المُنتظرة طويلاً كانت منقوصةً. فبالرَّغم من التجربة الموجعة لمئات الآلاف من ضحايا النظام القديم، لاسيما أُولئك الذين استطاعوا النجاة من الموت، إِلَّا أَنَّ الكثير من حقوقهم الشخصيَّة ضاعت وسط زحمة الأحداث العامَّة، حيث كلُّ شيء كان مُؤجَّلاً، كسباً للوقت ورغبة في استتباب الوضع العام للبلاد.
يقول دورفمان: (… وفيما أَنا أَرقُب بدهشة لجنة التحقيق تلكْ وهي تقوم بإنجاز مَهَّمتها الشاقة والشائكة، بدأتُ أُدرك شيئاً فشيئاً، وببطء، إننَّي أعثر أَخيراً على الإجابة عن السُّؤال المُلتبس للحكاية الذي ظلَّ يُدوّي في رأسي لسنوات عديدة. وكانتْ الإجابة هي إنَّ اعتقال المرأة للرجل الغريب في منزلها واخضاعه إلى محاكمة شخصَّية لا يمكن أن تتمَّ في دولة يتربَّع على السلطة فيها دكتاتور، كما جرى في زمن تلك الحادثة التي قرأتها في تلك الصحيفة، بل ينبغي أن تتمَّ في دولة هي في مرحلة انتقال إلى نظام ديموقراطي، حيث جراح الكثير من الشيليين لم تندملْ بعدْ، وحيث الكثير من الجُناة لا زالوا أحراراً يتساءلون برعب عن المصائر التي تنتظرهم فيما لو تمَّ الكشف عن جرائمهم.
لقد أصبح واضحاً أن الطريقة التي يُمكن أن نجعل فيها من الزَّوج الذي تعرَّضتْ زوجته للاغتصاب والتعذيب أن يعيش حالة رهانٍ مروّعة ومربكة بوصفه زوجاً لتلك المرأة التي اعتقلت ذلك الرجل الغريب في المنزل من جانب، ومن جانب آخر، باعتباره عضواً في لجنة التَّحقيق ومحامي ينبغي عليه الدفاع عن ذلك الشخص الذي من الممكن حقاً أن يكون قد اغتصب زوجته وعذبها!، وهو الوضع المشابه، إلى حدّ ما، بوضع المحامي العجوز الذي عَّينتْه حكومة باتريسو إيلوين لرئاسة هيئة التحقيق “ريتيج”).
(على المرء قول أكبر قدر ممكن من الحقيقة بالقدر الذي يمكن تحملّه)
لم يتطلَّب من دورفمان الوقت الطويل لاتّخاذ قرار حاسم بشأن العمل، وكان القرار أخيراً، أَنَّ الهدف هو كتابة نصّ مسرحي وليس رواية.
وبالفعل فقد أَتَّم كتابة “الموت والعذراء” عام 1991 وهو في نيويورك، إِلّا أَنَّه أَرجأَ إرسالها إلى تشيلي، خشية من ردود فعل سلبيَّة يمكن أن تثيرها أسئلتها المفعمة بخيارات صعبة، وهي الأسئلة التي كانت تسعى شخصيَّات المسرحية ذاتها إِلى فهمها والإِجابة عن جُملةٍ منها، وهي ذات الأسئلة التي كان يطرحها الشيليُّون على أنفُسهم في السّر، والتي نادراً ما تجد من يرغب في طرحها علناً:
ـ كيف يُمكنُ للجلاَّد والضَّحية العيش في مكان واحد؟
ـ هل بالإمكان مُعافاة بلدٍ قاسى من صدمة القمع والكبت ولا زال الخوفُ من إِبداء الرَّأي سائداً في جنباته؟
ـ كيف يُمكن الوصول إلى الحقيقة إذا كان الكَذِبُ قد أصبح عادةً؟
ـ كيف يُمكننا الإِبقاء على الماضي حيّاً، شرط ألا نكون سُجناءه؟ وكيف يُمكننا أن ننسى ذلك الماضي دون المُخاطرة بأن لا يتكرَّر في المستقبل؟ ثّمَّ ما هي عواقب محو صورة ذلك الماضي وهناك حقيقةٌ تهمسُ في آذاننا أو تنبحُ في وجوهنا؟
ـ هل من المنطقيّ التضحية بالحقيقة من أَجل ضمان الطُّمأنينة والأمن؟ وهل الناسُ أحرار حقّاً في بحثهم عن العدالة والمُساواة فيما تهديدات العسكر تلازمهم كالوساوس؟ وهل بالإمكان تجنَّب العنف في البلاد في ظروف كهذه؟ وما مقدار ما نحن، جميعاً، ودون استثناء، مُذنبون إزاءَ ما حدث لأولئك الذين قاسوا أكثر من غيرهم؟
ومن الأَرجح أَنَّ المأزق الأكبر هو، كيف يُمكننا مواجهة كُلّ هذه المعضلات، دون أن يّؤثّر ذلك في تقويض الإِجماع العام الذي هو ضرورةٌ لترسيخ الاستقرار للمُضيّ في تحقيق الديموقراطيَّة؟
كتب دورفمان يومها قائلاً: “كنتُ أُدركُ جيداً أننَّي سأُنتقد بحدَّةٍ وضراوةٍ في بلادي من البعض لأنني “هززتُ القارب بقوَّة” عبر تذكيري الناَّس بوقع صورة الإرهاب والعنف الذي قاسوه طوال تلك الفترة الطويلة في وقت مطلوب منَّا جميعاً أن نكون حذرين الى حد كبير من حالة كهذه.
لقد شعرتُ، على أي حال، أَنَّني كمواطن، ينبغي عليَّ أن أَتحلَّى بروح عالية للمسؤولية، وبوصفي كاتباً، عليَّ أَن أُجيب على النداء العاصف والمُروِّع لشخصيَّاتي، مُقوِّضاً ذلك الصمت الذي كان يُلقي بوطأته على كاهلهم. كنتُ أتأمَّل أُولئك الأَصدقاء، ممَّن كانوا يتابعون كتاباتي بودّ، وخوفهم الجميل ذاك من أننَّي، ربما، أُسهم، ومن دون قصد، في خلق مأزق جديد لتلك الديموقراطية الهشَّة، إِلّا أَنَّني مع ذلك كنتُ على يقين من قبل، وزاد الآن يقيني أكثر من أي وقت مضى، بأَنَّ الديموقراطية الهشَّة لا يُمكن أن تتصلَّب ويقوى عُودُها إِلّا عَبر المكاشفات واتّباع نهج المصارحة والوضوح، ليرى الجميع كيف ستتفتَّح وتُزهر الأعمال الدراميَّة العميقة الرؤى، وليرُونَ أَيضاً تلك الأحزان العميقة والآمال الكبيرة التي تُشكّل جميعاً مُرتكزات وجودٍ صلبة لتلك الديموقراطية. بهذه الطريقة فقط، وليس عَبر جلد الذات، نستطيع أن نتفادى تكرار ما حدث لنا..”.
في عمله هذا وفي جُلّ أعماله الأخرى لا يسعى دورفمان أن يكون صوتاً بديلاً لصوت شخصياته، إنما يمنح تلك الأصوات فرصة ومصداقية كاملة لتقول كلمتها، مُشيّداً جسوراً بين ضفاف شخصياته تلك كي تلتقي وتتحاور. أما المحاكم التي يقيمها
فهي بمثابة منابر أخلاقية تتعامل مع الحقيقة وتخاطب الضمير الإنساني، قَصاصَها ينأى عن مدلوله المادي والواقعي، ذلك المتمثل بالسجن أو الموت، ليتَّخذ له دلالات رمزية توخز الضمير وتلامس شغاف القلب، مستهدفة من ذلك نوعاً من التطهير
الروحي. إنها عقوبات لا تتعدى أكثر من إحساس الجاني بفداحة جُرمه وشعوره بالأسف والندم والتوبة إزاء ضحيته جرَّاء تلك الخطيئة، ومن ثمَّ طلب الصفح.
إن مأزق ﭙاولينا، الشخصية المحورية في المسرحية، هو مأزق جميع الناس الذين أُسكتت أصواتهم، أولئك الذين يطلق عليهم الكاتب مجازاً بـ “المناطق الخاضعة للرقابة”.
يدعو دورفمان في العهد الديموقراطي الجديد تلك الأصوات المكبوتة أن تخرج إلى النور لتقول كلمتها بصوت عال دون تردد أو خوف.
كتب يومها: “… إن لدى الكثير من الناس الذين تعرضوا للتعذيب قصصهم المكبوتة، تلك القصص التي لم ُتحكى بعد. أعرف أن التعذيب هو الجريمة الأولى، نعم، لكنني أؤكّد أن الجريمة الأكثر بشاعة هي الصمت! وبصفتي كاتباً، يُقلقني جداً هذا الصمت، وبوسعي عمل الكثير بشأنه..”.
وهكذا يُصبح دورفمان راوياً صادقاً وحقيقياً لتلك الأحداث المأساوية حقاً. ففي عالمه التخييلي يُصبح فن القص أو سرد الحكاية شكلاً من أشكال الحرية، فيما الصمت أحد أشكال العبودية.
مسرحيته “الموت والعذراء” لم تكن تحكي فقط عن بلده شيلي أو أي بلد عانى ويعاني الخوف وهو بحاجة قصوى لمعرفة مغزى ذلك الخوف وآثاره، وليس فقط عن التأثيرات الطويلة الأمد للتعذيب والقمع والعنف الذي مورس على الناس وعلى أوطانهم الجميلة، إنما تحكي أيضاً عن موضوعات أخرى كانت ولاتزال تُقلق دورفمان وتستحوذ على تفكيره بشكل متواصل:
ـ كيف يُمكنك قول الحقيقة إذا كان القناع الذي ترتديه يتطابق تماماً مع وجهك؟
ـ كيف يُمكن للذاكرة أن تُضلّلنا، ثم تُهـدينا وتُنقذنا في نفس الوقت؟
ـ كيف يُمكننا الاحتفاظ ببراءتنا وقد تناولنا الطعام مع الشيطان؟
ـ كيف يُمكن الصَّفح عن أولئك الذين آذونا بشكل يتعذَّر معه النسيان؟
ـ كيف يُمكننا العثور على لغةٍ سياسيةٍ طازجةٍ تنأى عن الشعاراتيَّة الخاوية والزائفة؟
ـ كيف يُمكن حكاية القصص التي هي على حد سواء، مألوفة وملتبسة، قصص يُدركها جمهور واسع من الناس، قصص لاتزال تتضمن طرائق تجريبية، قصص تعالج موضوعات خرافية وإنسانية مباشرة أيضاً؟
“الموت والعذراء” دراما تتحدث بلغة سياسية طازجة، وبانفعال حاد ذي مغزى عن تأريخ يتجاوز تخوم الأحداث الآنية أو تلك الخسارات الشخصية التي عادة ما ترافق التغييرات السياسية المفاجئة. إنها تتوق لإيصال خطاب مفاده أن في هذا الكوكب العجيب حيث تسود القوة والعنف، ثمة إمكانية ما للناس لمعرفة ما حدث لهم حقاً، ومن المحتمل جداً أنَّ بإمكانهم سرد قصصهم وعذاباتهم في الأقل. هكذا وبهذا المعنى، تصبح هذه المسرحية ابنة زمنها.
***
(*)
يمكن الاطلاع على نص “الموت والعذراء” كاملاً على (أون لاين) في صحيفة السفير “كتاب في جريدة” على الرابط التالي:
https://images.app.goo.gl/2YQak8HQz2WDss418



